ملخص المقال
وقفة مع النفس لمحاسبتها ومعاتبتها وتخليصها من كل ما علق بها، وفي هذا المقال يعرض الكاتب نموذجين في الاستجابة لله بأمر الذبح. فأي الذابحين أنت؟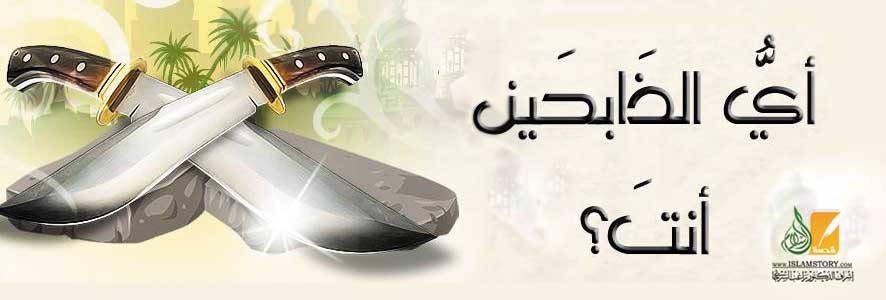
أهم مقتطفات المقال
الأمر في حقيقته صلة بين قلوب العباد، وذلك النبع الشفيف الرقراق: نبع الإيمان بالغيب، والثقة باللّه، والاستعداد لتصديق ما يأتي من عنده. إمّا أن تكون صلةً حقيقيةً بالاستجابة والاستسلام والتنفيذ، أو أنها مقطوعة بالتلكؤ في الاستجابة للتكاليف، وتلمس الحجج والمعاذير، والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان!
يتجهز المسلمون في هذه الأيام المباركات لذبح الأضاحي، وكذا الحُجَّاج سيذبحون هديهم في الوقت نفسه، ومشهد الذبائح وإهراق الدم في يوم النحر (يوم العيد الأكبر) يجعل مخيلتنا تعود مباشرة إلى ذكرى نبي الله إبراهيم عليه السلام والاستنان بسنته في الذبح والتضحية، وذكرى إبراهيم تثير في النفس حديثًا شائقًا في معاني وتجليات التضحية لله، لكن قبل أن نقف هذه الوقفة مع قصته، فإننا سنتجاوز زمانه كثيرًا، لنقف على صورة متناقضة من آبنائه وحفدته من بني إسرائيل، وذلك من باب "وبالضد تتميز الأشياء".
مجرد بقرة:
في سورة البقرة صوَّر الله مشهدًا في غاية الأهمية، لذلك جعله اسمًا وعَلمًا للسورة، وهي أطول سور القرآن وأجمعها لأحكام الدين، وذلك أنه لمَّا قَتل بنو إسرائيل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وحصل الاختلاف في القاتل، طلبوا من موسى أن يخبرهم بالقاتل، فأراد الله أن يختبرهم بذبحِ بقرةٍ، فكان هذا الحوار:
{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}
وهذه الصيغة عند المؤمنين تكفي للاستجابة والتنفيذ. فالذي يخبر بالأمر هو رسولهم، وهو ينبئهم أن هذا ليس أمره وليس رأيه، إنما هو أمر اللّه، الذي يسير بهم على هداه، أمر الله، فمنذا يعترض على أمره؟ لكن كان جوابهم..
{قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا}
أتهزأ بنا يا موسى، نسألك عن أمر القتل، فتأمرنا بذبح بقرة! كان جوابهم سفاهة وسوءَ أدب، واتهامًا لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم ويسخر منهم! كأنما يجوز لإنسان يعرف اللّه -فضلًا على أن يكون رسولًا من عنده- أن يتخذ اسم اللّه وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس!!
{قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ}
وكان في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم، ويرجعوا إلى ربهم، وينفذوا أمر نبيهم، فيمدوا أيديهم إلى أي بقرة فيذبحونها، فإذا هم مطيعون لأمر اللّه، منفذون لإشارة رسوله. ولكن طبيعة التلكؤ والالتواء تدركهم، فإذا هم يسألون:
{قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ}
والسؤال عن الماهية في هذا المقام -وإن كان المقصود الصفة- إنكار واستهزاء.. ما هي؟ هي بقرة.. بقرة وكفى!
{قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ}
وهنا يأخذهم إلى تفصيل قريب، سهل الوصول إليه، إنها ليست صغيرة ولا كبيرة، بل وسط بين الأمرين، ويردهم موسى إلى الجادة في نهاية جوابه حتى يقطع جدلهم، وينصحهم في حزم أن يمتثلوا الأمر، ولا يشدّدوا فيشدد اللّه عليهم، فراحوا يسألون عن اللون!
{قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا}
{قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ}
وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن بقرة -مجرد بقرة- بل عن بقرة متوسطة السن، لا عجوز ولا صغيرة، وهي بعد هذا صفراء فاقع لونها، وهي بعد هذا وذاك ليست هزيلة ولا شوهاء: «تَسُرُّ النَّاظِرِينَ».. وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع!
ولقد كان فيما تلكأوا كفاية، ولكنهم يمضون في طريقهم، يُعقِّدون الأمور، ويشددون على أنفسهم، فيشدد اللّه عليهم. لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية:
{قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ}
حتى في اعتذارهم عن هذا السؤال وعن ذلك التلكؤ جاءوا بقول باهت:«إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا».. والحقيقة أن البقر كله متشابه، وأن الله لم يرد بدايةً تميزًا منها، كان يكفي أيٌّ من هذا المتشابه، إنَّ الله لا يريد نوع البقر ذاته ولا هو بحاجة لشيء من امتيازاته، الذي أراده الله منهم هو الاستجابة لأمره، والطاعة له سبحانه. ولم يكن بد -كذلك- أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيدًا، وأن تزيد دائرة الاختيار المتاحة لهم حصرًا وضيقًا، بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة،كانوا في سعة منها وفي غنى عنها:
{قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا}
لقد طال الحوار جدًا، وكثر الجدل، ولك أن تضيف المسافات بين {قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ} وبين {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ} من دعاء ولجوء إلى الله من موسى وإجابة من رب العالمين، في كل طلب من مطالبهم!!
ولم تعد بقرةً متوسطة العمر، صفراء فاقع لونها فارهة فحسب. بل لم يعد بد أن تكون -مع هذا- بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع، وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها علامة. هنا فقط! وبعد أن تعقد الأمر، وتضاعفت الشروط، وضاق مجال الاختيار:
{قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ}[البقرة: 67 - 71]
أي: فطلبوا البقرة الجامعة للأوصاف المطلوبة ووجدوها، فلما اهتدوا إليها ذبحوها. وهذا عند البلاغيين يسمى إيجاز بالحذف، وسببُه -حسب ظني- أنه لما طال الحوار، وطال التلكؤ واللجاج، حُذف ما قد يكون أطول وأعقد، ليتخيله القارئ بأوسع مما يمكن أن يكون، فإن كان حالهم كذلك في استفهام الأمر، فكيف عن حالتهم وقت تنفيذه؟ والتعقيب بقول الله {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} يرسم سمة اللجاجة والتعنت وتمحل المعاذير والتلكؤ في الاستجابة، وفي الآثر: «إنَّما أُمِرُوا بأدنى بَقَرةٍ، ولكنَّهم لمَّا شدَّدوا على أنفسِهم شدَّد اللهُ عليهم، وايمُ اللهِ لو أنَّهم لم يَستَثْنوا (قولهم: وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ) ما بُيِّنَتْ لهم آخِرَ الأبَدِ»[1].
ذبحٌ فريد!!
ولنعود إلى ذكرى إبراهيم عليه السلام، كان عليه السلام أبًا شفوقًا قد حُرم الذرية، حتى إذا بلغ الشيخوخة وكاد أمله ينقطع من الولد، إذا بالذي اصطفاه خليلًا في الدنيا يرزقه غلامًا زكيًا وفيًا، حتى إذا بلغ معه السعي، وأصبح يليق بوراثة الحكمة والنبوة، أو بمعنى آخر أصبح الساعد الأيمن لهذا الشيخ الكبير، يعتمد عليه في المهمات والملمات، وبنى معه أول بيت وضع للناس {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ}[البقرة: 127].
حتى إذا بلغ هذه السن المنتجة النافعة التي تملأ قلب الأب سرورًا وبهجة وتكحل عينيه قرة وجمالًا، إذا بالذي يُنعم عليه يمتحنه برؤية منام يذبح فيها هذا الولد الذي قر عينه بعد الكبر، ورؤيا الأنبياء وحي[2]، {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى} لقد سارع إلى ابنه وحبيبه يعرض الأمر عليه ليرى رأيه فيه، أي مشاعر أصابته وقتها؟ وأصابت ابنه لحظة سماعه؟ وأصابت الأمّ كذلك؟ ولكنّ الابن العليم الحكيم -كما وصفه ربه- كان عند حسن ظن أبيه كما كان أبوه عند ظن ربه سبحانه، فبادر يقول لأبيه: {يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ}[الصافات: 102].
إنه لم يكن أمرًا صريحًا من الله مباشرة، هناك فرصة للتهرب.. فرصة للتمحل.. فرصة للتأويل! ومع ذلك أقرّا أنه أمر الله ويجب نفاذه والاستجابة السريعة له..{افعل ما تؤمر}، فالأمر ليس أمرك، فأنت الحنون الشفوق وأنت الرحيم الرقيق، والله أرحم منك، وأكرم وأبر، فما دام قد أمر بالذبح فهو الرحمة بعينها، وهو والحنان عين الحنان.
ويسير إبراهيم وإسماعيل إلى محل التنفيذ، وفي هذه اللحظات -التي تُسكَب فيها العبرات، وتُحتَبس من أجلها الأنفاس داخل الصدور، فلا ترى إلا المدامع في العيون- وضع إبراهيم عليه السلام السكين على رقبة ولده ليحزها، فسُلِبَت السكين حدها كما سُلِبت النار -من قبل- إحراقها.. وجاءت البشرى فنودي إبراهيم عليه السلام: {أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ}[الصافات:104- 106].
إنه موقف فريد لم يحدث من قبل وما سمعنا أنه حدث من بعد، يقول ابن القيم: ليس العجب من أمر الخليل بذبح الولد، إنما العجب من مباشرة الذبح بيده، ولولا الاستغراق في حب الآمر [الله] لما هان مثل هذا المأمور؛ فلذلك جعلت آثارها مثابة للقلوب تحن إليها أعظم من حنين الطيور إلى أوكارها[3].
أي الذابحين أنت؟
إن الموازنة بين الموقفين تظهر الفرق الشاسع والهوة السحيقة بين العبودية لله في أعلى وأجل معانيها، وبين المراوغة وسوء الأدب مع الله تعالى وأنبيائه، وأي موازنة بين من أمره الله بذبح ولده فنفذ، وبين من أمره ببقرة فماطل!!
أي مقابلة بين {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} وبين: { إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}
أي التقاء بين {أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا} وبين {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}
الأمر في حقيقته صلة بين قلوب العباد، وذلك النبع الشفيف الرقراق: نبع الإيمان بالغيب، والثقة باللّه، والاستعداد لتصديق ما يأتي من عنده. إمّا أن تكون صلةً حقيقيةً بالاستجابة والاستسلام والتنفيذ، أو أنها مقطوعة بالتلكؤ في الاستجابة للتكاليف، وتلمس الحجج والمعاذير، والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان!
ولعلنا نلمح قضية صفاء الحب لله وإخلاصه، فالأمر كان بذبح بقرة دون غيرها من الحيوان؛ لأنها من جنس ما عبد بنو إسرائيل، وهو العجل، ليهون عندهم أمر تعظيمه. {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ}[البقرة: 93].
أما إبراهيم، فـ«لمّا كان منصب الخُلة وهو منصب لا يقبل المزاحمة بغير المحبوب وأخذ الولد شعبة من شعاب القلب، غار الحبيب على خليله أن يسكن غيره في شعبة من شعاب قلبه فأمره بذبحه، فلمَّا أسلم للامتثال خرجت تلك المزاحمة وخلصت المحبة لأهلها فجاءته البشرى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}»[4].
فرق كبير بين الذَابحين.. فرق كبير، بين: {أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا} وبين: {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}!
لقد مضت السنون على القصتين وبقيت الشعيرة في أمتنا، أن نبتلى بالذبح لله وحده، وأن نهرق من أجله دماء الأضاحي والهدي، فأي الذابحين أنت؟
إن الأضحية رمز، والرمز يحمل في طياته الكثير من المعاني، إنها وقفة مع النفس لمحاسبتها ومعاتبتها وتخليصها من كل ما علق بها، علينا بتهذيب القلوب قبل ذبح الأضحية فالله يقول سبحانه: {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ}[الحج: 37].
ولستُ أعني الأضحية في ذاتها، بل إنني أقصد كل التكاليف والأوامر الشرعية من الله ورسوله، أن نحقق الاستجابة الحقيقية بحب وصفاء ورضا واحتساب للأجر، بنو إسرائيل ذبحوا وإبراهيم ذبح (وإن كان لم ينفذ) كلاهما ذبح في الأخير، لكن أيهما أقرب إلى الله، الذين عبَّر عنهم بقوله: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ}، أم الذين قال عنهم: { أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ... قَدْ صَدَّقْتَ}؟!
كُلنا يفعل الطاعة -إذا فعل- لكن أيّنا يفعلها باستسلام، وخفة وحب وإخلاص ورضا عن ربه؟ وأيّنا يفعلها وهو متثاقل متأفف متألم يعدد مشاقعها ويسعى في تخفيفها وتأويلها والتعذر عنها؟
أيّنا الذي حقق العبودية بمعناها الحقيقي؟
سؤال لا بُّد من إجابة صادقة عنه.. وكل عام وأنتم بخير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه الطبري في تفسيره (2/205)، وقال ابن حجر: وهو معضل. وأخرجه بِنَحْوِهِ سعيد بن مَنْصُور في سننه، عَن عِكْرِمَة مَرْفُوعًا، وقال محققه: سنده ضعيف لإرساله، وهو صحيح إلى عكرمة.
انظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور (2/ 565)، دراسة وتحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد - دار الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1997 م.
[2] روى هذا الأثر، الحاكم في المستدرك (3613)، والطبراني في الكبير (12302)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده حسن.
[3] ابن القيم، بدائع الفوائد (3/ 223).
[4] السابق نفسه.






![نصيحتي لك: اذكر الله [1 / 12] نصيحتي لك: اذكر الله [1 / 12]](https://islamstory.com/images/upload/content_thumbs/1913613138ragheb-al-serjany-videos.jpg)


التعليقات
إرسال تعليقك