الحضارة
سبق وريادة وتجديد
اهتمت الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة والأموية والعباسية بالعلوم والمدنية كما اهتمت بالنواحي الدينية فكانت الحضارة الإسلامية حضارة تمزج بين العقل والروح، فامتازت عن كثير من الحضارات السابقة. فالإسلام دينٌ عالمي يحض على طلب العلم وعمارة الأرض لتنهض أممه وشعوبه، وتنوعت مجالات الفنون والعلوم والعمارة طالما لا تخرج عن نطاق القواعد الإسلامية؛ لأن الحرية الفكرية كانت مقبولة تحت ظلال الإسلام، وامتدت هذه الحضارة القائمة بعدما أصبح لها مصارفها وروافدها لتشع على بلاد الغرب وطرقت أبوابه، وهذه البوابة تبرز إسهامات المسلمين في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية والبيئية، خلال تاريخهم الطويل، وعصورهم المتلاحقة.
ملخص المقال
بيان لأهم المعالم الحضارية في مدينة الموصل العراقية ومكانتها العلمية بين بلدان العالم الإسلامي وأشهر علمائها وومدارسها وآثارها المعمارية
تظلُّ مدينة الموصل شاهدة على ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية من رقيٍّ وتقدُّم، وما وصل إليه المعماري المسلم من إبداعٍ وتميُّز، وفي تلك السطور بيانٌ لأهمِّ المعالم الحضارية في مدينة الموصل العريقة، وبيان مكانتها العلمية بين بلدان العالم الإسلامي.
الأسوار
يُحيط بالموصل سورٌ كبيرٌ كان أول من خطَّه هو سعيد بن عبد الملك بن مروان الذي تولَّى الموصل في خلافه أبيه عام (65-89هـ=685-708م)، ثم إنَّ مروان بن محمد وسَّع السور الذي بناه سعيد في الأماكن التي اتَّسعت فيها المدينة ورمَّم ما انهدم منه، وذلك في أوائل القرن الثاني للهجرة، وقد بقي سور سعيد حتى هدمه هارون الرشيد عام (180هـ=797م) على إثر ثورة أهل الموصل عليه، وبقيت المدينة بلا سورٍ حتى عام (474هـ=1081م)، فبنى شرف الدولة العقيلي سورًا للموصل قليل الارتفاع ولم يعمل له فصيلًا، ولا أحاطه بخندق، وفرغ من عمارته بعد ستَّة أشهر، ثم إنَّ جكرمش -أحد ولاة السلاجقة في الموصل- رمَّم سور المدينة، وبنى له فصيلًا، وحفر الخندق وحصَّن المدينة عام (468هـ=1076م)، وفعل مثل هذا جاولي عام (502هـ=1109م).
ولمـَّا تولَّى الموصل عماد الدين زنكي واتَّخذها عاصمةً لملكه رأى من الضروري أن يُحكِم تحصين المدينة؛ فوسَّع السور من الجهة الشمالية من المدينة، وأدخل الميدان بما فيه قصور الإمارة داخل السور الجديد الذي بناه، كما أنَّه رفع السور من سائر جهاته وأحكمه، وعمَّر الخندق الذي يُحيط به عام (527هـ=1133م)، وصار للميدان سوران أحدهما السور السلجوقي، والثاني السور الأتابكي الذي بناه عماد الدين زنكي.
وقد كان لسور الموصل تسعة أبواب في العهد الأتابكي ومنها: الباب العمادي وفتحه عماد الدين زنكي عام (527هـ=1133م) وسُمِّي باسمه، وكان يُؤدِّي إلى الربض الأعلى من المدينة ولم يزل موقعه يعرف بهذا الاسم.
أبواب الموصل
ومن أهمِّ أبواب مدينة الموصل باب سنجار، وكان يقع في اللحف الغربي من تلِّ الكناسة، ولم يزل مكانه إلى اليوم يُسمَّى باب سنجار ويُؤدِّي إلى الجهة الغربية من المدينة، وهو من أقدم أبواب المدينة، وكان هذا الباب من أوسع أبواب المدينة يُحيط به من الداخل مرافق كثيرة للجيش وخيوله وعتاده، ومن الأبواب الغربية -أيضًا- باب كندة، وباب الجصاصة، وكذلك ما يُعرف بالباب الغربي وهو الباب الذي فتحه عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود، ولم يكن قبله هناك باب، وانتفع به أهل ذلك الصقع.
أمَّا الأبواب الجنوبية فمنها باب العراق؛ وهو الذي كان يُؤدِّي إلى الجهة الجنوبية -جهة العراق- ولم يزل محلُّه معروفًا بهذا الاسم، وباب القصَّابين؛ وهو من أبواب الموصل القديمة، وبقي يعرف بهذا الاسم إلى القرن السادس للهجرة، وهو كما يدلُّ عليه اسمه كان يُؤدِّي إلى سوق القصَّابين.
ومن الأبواب الشرقية باب الجسر؛ وهو من أبواب الموصل القديمة أيضًا، وبقي معروفًا بهذا الاسم إلى أيَّامنا هذه، وهو يقع في مدخل الجسر الخشبي القديم الذي رفع عام (1352هـ=1934م) على أثر بناء الجسر الحديدي المسمَّى جسر الملك غازي، وهو من أشهر أبواب المدينة؛ لأنَّه الباب الوحيد الذي كان يصل المدينة بالجهة الشرقية منها، وباب المشرعة كان يقع قريبًا من دور المملكة يُؤدِّي إلى النهر، وقد بنى عليه الملك سيف الدين غازي عام (541هـ=1147م) رباطًا؛ والرباط يُسمَّى اليوم مقام عيسى دده.
قلعة الموصل
تقع قلعة الموصل على الأرض المرتفعة التي تُشرف على نهر دجلة وعين كبريت، وهي في شمال مدينة الموصل، وكانت تجاور دور المملكة، ولا يُعرف من الذي أنشأ هذه القلعة أوَّل مرَّة، وأقدم ذكرٍ لها عُثر عليه: أنَّ البساسيري (450هـ=1058م) حاصرها أربعة أشهر، وبعد أن استولى عليها هدمها وعفي أثرها، وأنَّ الأتابكيِّين اهتمُّوا بهذه القلعة فوسَّعوها وأكملوا عمارتها، وصارت تتَّسع لآلافٍ من أفراد الجيش، وفيها مخازن للمؤن والعتاد ولوازم الحرب.
ومن الذين اهتمُّوا بعمارة القلعة فرمَّم سورها، وأحكم أبراجها، وجدَّد ما انهدم من مرافقها؛ هو فخر الدين عبد المسيح وزير سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود، وكان يُحيط بالقلعة سورٌ غير سور مدينة الموصل، ومن أبوابه: باب القلعة؛ وكان يُؤدِّي منها إلى الميدان، وباب السر؛ وكان يُؤدِّي منها إلى النهر من جهة عين كبريت، وهو أمنع أبوابها.
وكانت القلعة مركزًا هامًّا في الدولة يكون فيها العتاد والذخيرة، ويتولَّى حراستها جيشٌ كبيرٌ يُشرف عليهم دزدار مخلص معروف بالشجاعة والحزم والتدبير، وقد يفوض لدزدار قلعة الموصل النظر في أمور القلاع والإشراف على من فيها.
وقد بقيت القلعة عامرة حتى سنة (660هـ=1262م)، وفي هذه السنة حاصر الموصل سنداغو ونصب عليها المنجنيقات وتحصن في القلعة (ياسان)، وشدَّد المغول الحصار على القلعة، ورموها بالأحجار والنار، ففتحوا المدينة وهدموا قلعتها، وهكذا هُدمت هذه القلعة الحصينة وأصبحت خرابًا.
البيمارستانات
كان في مدينة الموصل بيمارستانان: أحدهما داخل المدينة، والثاني في الربض الأسفل منها، بناه مجاهد الدين قيماز تجاه جامعه الذي بناه على دجلة، الذي لم يزل باقيًا إلى اليوم ويُعرف بالجامع الأحمر، وهذا البيمارستان جميلٌ جدًّا، وفيه كلُّ ما يحتاجه المريض من أسباب المعالجة والنزهة والترويح عن النفس والتخفيف عن المريض.
كما كان في المدينة بيمارستانٌ خاصٌّ بمعالجة المجانين، وكانت المعالجة في البيمارستان بلا ثمن؛ يدخله المريض فتجري عليه الفحوص اللازمة، ثم يُوصف له الدواء، ويُعطى إليه من صيدليَّة البيمارستان، وإذا احتاج المريض أن يكون تحت إشراف طبيب فإنَّه كان ينام في البيمارستان، ويجري عليه الطعام والشراب والدواء، وكلُّ ما يحتاجه ممَّا يُخفِّف مرضه، ويكون هذا بلا عوض.
المساجد
وُجِد في الموصل على مرِّ العصور العديد من المساجد والجوامع العظيمة الجميلة، ومِنْ هذه المساجد مسجد خزرج؛ ويقع في محلَّة خزرج، وهو من أقدم مساجد الموصل، أُسِّس في القرن (الأول للهجرة= السابع الميلادي)، وسكنت قبيلة خزرج حوله بعد تمصير الموصل فنُسب إليها، ولم تزل محلَّة خزرج تُسمَّى بهذا الاسم ويسكنها بعض البيوت من قبيلة خزرج.
وهناك الجامع الأموي؛ وهو أول جامعٍ بُنِي في الموصل، بناه عتبة بن فرقد السلمي عام (17هـ=119م)، وبنى إلى جنبه دار الإمارة، ثم وسَّعه عرفجة بن هرثمة البارقي، ولمـَّا تولَّى مروان بن محمد الموصل هدم الجامع ووسَّعه، وبنى فيه مقصورة ومنارة، وبنى إلى جنبه مطابخ يُطبخ بها للفقراء في شهر رمضان، وصار يُعرف (بالجامع الأموي).
وفي عام (167هـ=784م) أمر الخليفة المهدي عامله موسى بن مصعب بن عمير أن يضيف إلى الجامع الأسواق التي كانت تُحيط به، فهدمها مصعب مع المطابخ وأضافها إلى الجامع ووسَّعه، وكانت حالة الجامع غير مرضيةٍ في القرن (الخامس للهجرة= الحادي عشر الميلادي)؛ وذلك على عهد الولاة السلاجقة، فتداعى بنيانه وترك الناس الصلاة فيه إلَّا يوم الجمعة.
وفي عهد الأتابكيِّين اهتمُّوا به كما اهتمُّوا بكافَّة مرافق المدينة وتجديدها، فجدَّدوا عمارته عام (543هـ=1149م)، وذلك على يد سيف الدين غازي الأوَّل بن عماد الدين زنكي، وكانوا يُسمُّونه الجامع العتيق تمييزًا له عن الجامع الجديد -الجامع النوري- واهتمَّ الأتابكيُّون بتزيينه وزخرفته، والجامع في الوقت الحاضر صغيرٌ تُقام به الجمعة، وقد اتخذ قسم كبير من فنائه مقابر عامَّة وتُسمَّى مقبرة الصحراء، وكانت تُسمَّى مقبرة الجامع العتيق.
ومن الجوامع -أيضًا- الجامع النوري؛ الذي بناه نور الدين محمود زنكي عندما دخل الموصل عام (566هـ=1171م)، وكان في المدينة جامعٌ واحدٌ يُجمع به، وقد ضاق بالمصلِّين خاصَّةً وأنَّ المدينة قد ضاقت بسكَّانها، وذكروا له أنَّ في وسط الموصل خربةٌ واسعةٌ تصلح أن تكون جامعًا كبيرًا؛ لوقوعها في وسط أسواق المدينة، فركب نور الدين إلى محلِّ الخربة وصعد منارة مسجد أبي حاضر، وأشرف على الخربة، وأمر أن يُضاف إليها ما يُجاورها من الدور والحوانيت، وأن تُؤخذ من أصحابها برضاهم، بعد أن يُدفع إليهم أثمانها.
وقد قام ببناء الجامع شيخ نور الدين، وهو معين الدولة عمر بن محمد الملا، وبقي يشتغل في عمارة الجامع ثلاث سنوات، وعندما زار نور الدين الموصل مرَّةً ثانيةً عام (568هـ=1173م) صلَّى بجامعه، بعد أن فرشه بالبُسط والحصر، وعيَّن له مؤذِّنين وخدمًا وقومة، ورتَّب له كلَّ ما يلزمه، كما أنَّ نور الدين أوقف له أوقافًا كثيرةً لصيانته وأدامته والصرف على من يتولَّى أموره، وبنى به نور الدين مدرسة.
ومن الجوامع -أيضًا- الجامع المجاهدي؛ الذي بناه أبو منصور قيماز بن عبد الله الزيني، الملقَّب مجاهد الدين، من أهل سجستان، أحد كبار الدولة الأتابكية، وكان في الموصل على عهده جامعان يُجمع بهما: الجامع الأموي والجامع النوري. وكان الربض الأسفل كالمدينة بعمرانه وأسواقه، ويُلاقي سكانه صعوبةً في الذهاب إلى أحد الجامعين لأداء صلاة الجمعة، فقرَّر أن يبني جامعًا في هذا الربض ليُريح الناس.
وفي عام (572هـ=1177م) باشر بعمارة الجامع، واستخدم في بنائه أمهر البنائين والفنانين، وصرف عليه مبلغًا كبيرًا، واستمرَّ العمل به خمس سنين، فكان من الجوامع المعدودة في بلاد الجزيرة، وأُقيمت فيه صلاة الجمعة عام (575هـ=1180م) قبل أن تكمل عمارته، ولمـَّا كملت عمارته عام (576هـ=1181م) اعتنى مجاهد الدين في تزيينه بكتابات مختلفة وزخارف متنوِّعة؛ بعضها بالجبس، وبعضها بالآجر وبالمرمر المطعم بالصدف، والجامع في الوقت الحاضر أصغر ممَّا كان عليه في العهد الأتابكي، ويُسمَّى جامع الخضر أو الجامع الأحمر.
الحمامات
كان في المدينة العديد من الحمَّامات التي كان يرتادها أهل الموصل؛ فقد كان بها 200 حمام للرجال تُجاورها 200 حمام للنساء، و10 حمامات خاصَّة بالبنات فقط، كما تميَّزت -أيضًا- الموصل بحمَّامات الاستشفاء؛ فقد كان في الموصل حمَّام العليل، وكان من المحلَّات التي يرتادها أهل الموصل في فصلي الربيع والصيف، وخاصَّةً أصحاب الأمراض الجلدية، فكانوا يستشفون بمائها المعدني الحار، ويكون حمَّام العليل في الصيف مزدحمة بالسكان، فيبنون لهم عرائش على شاطئ دجلة يسكنونها، ولم يزل حمَّام العليل على ما ذكرنا حتى وقتٍ قريب.
الأسواق
كانت أسواق الموصل الرئيسة في العهد الأموي حول الجامع الأموي، وهو مركز المدينة في ذلك الوقت يُجاوره دار الإمارة، ثم إنَّ إسماعيل بن علي بن عبد الله العباسي نقل الأسواق إلى خارج المدينة عام (137هـ=755م) وبنى في وسطها مسجد أبي حاضر، ويُعرف بمسجد الشالجي في الوقت الحاضر.
كما أنَّ الخليفة المهدي كان قد وسَّع الجامع الأموي عام (167هـ=784م)، وأضاف إليه ما كان يُحيط به من الأسواق، وهكذا انتقلت معظم الأسواق الكبيرة إلى قرب الجامع النوري، وأخذت تتوسَّع هذه بتوسُّع المدينة حتى صارت الأسواق التجاريَّة المهمَّة تُحيط بالجامع النوري، وهو في وسط مدينة الموصل على عهد الدولة الأتابكية.
على أنَّ بعض الأسواق بقيت في محلِّها القديم في شرق الموصل، خاصَّةً الأسواق التي يحتاجها الفلَّاحونح كسوق القتابين، وسوق الشعارين، وسوق الأربعاء. ونشأت أسواقٌ أخرى قريبةٌ من باب الجسر؛ وهي الأسواق التي كان يمتار منها الفلاحون الذين يقصدون الموصل من الجهة الشرقية.
ويُعدُّ سوق الشعارين وسوق القتابين من أقدم أسواق الموصل؛ ويعود تاريخهما إلى القرن (الأول للهجرة= السابع الميلادي)، ولم يزالا معروفين إلى اليوم بهذا الاسم، وسوق الأربعاء، وتسمَّى أيضًا المربعة - جهار سوك؛ فسوق الأربعاء كانت تقع على الأرض التي يُطلق عليها "سوق الميدان" في الوقت الحاضر، التي تمتدُّ إلى قرب باب الجسر بما فيها القسم المجاور لها وتقع على النهر، وسوق الأربعاء من الأسواق القديمة في الموصل ورد ذكرها في أوائل القرن الثاني للهجرة، وبقيت سوق الأربعاء إلى القرن السابع للهجرة تُعرف بهذا الاسم.
وهنالك أسواقٌ أخرى كانت في أحيائها الداخلية وفي أرباضها؛ ففي الربض الأسفل السوق الذي بناه مجاهد الدين قيماز، وهو من الأسواق الكبيرة المعلومة في الموصل، ومحطُّ التجَّار الذين يأتون من الجهة الجنوبية.
ومن أسواقها الكبيرة داخل المدينة "جهار سوك" وهو يقع في وسط المدينة -أيضًا- في المحلَّة التي لم تزل تُسمَّى باسمه، ولقد ظلَّ هذا السوق إلى عهد قريب، ثم هُدِمت أكثر دكاكينه، وأُضيفت أرضها إلى شارع الفاروق.
وقد كانت أسواق الموصل ملتقى تجارة الشرق والغرب؛ حيث كانت تصلها القوافل التجارية من العراق محمَّلة ببضائع الهند، وتصلها قوافل إيران ومعها بضائع الصين وفارس، وتحطُّ بها قوافل أذربيجان وترسو فيها مئات الفلك المحمَّلة بحاصلات جزيرة ابن عمر وما يُجاورها من بلاد الأناضول، ومن الموصل تخرج القوافل العديدة إلى بلاد سورية محمَّلة ببضائع الشرق وحاصلاته، وتسير إلى سواحل البحر الأبيض المتوسِّط.
كما كانت الصنائع في الموصل متقدِّمة، وصارت المصنوعات الموصليَّة تصدر إلى الهند شرقًا وإلى أوربا غربًا، ومن هذه الصنائع النسيج الموصلي المعروف (بالموسلين)، وصناعة التكفيت في المعادن، وترصيع الخشب والرخام، وصناعة الخزف، والزجاج، والزخارف الجبسيَّة، وغير ذلك.
ونبغ في الموصل كثيرٌ من الفنانين الذين كان يرجع إليهم، وكانت بعض تحفهم التي يبتكرونها مثالًا لفنَّاني الشرق يعكفون على درسها وتقليدها.
ولقد انتشرت القيسريَّات في الموصل، ومنها قيسريَّة خاصَّة لبيع الروائح العطرية، وتُسمَّى قيسريَّة المسك، وفيها (12) دكانًا، ومن القيسريَّات الكبيرة الشهيرة قيسرية الجامع النووي، وكان فيها (699) دكانَا، والقيسريَّة التي بناها مجاهد الدين قيماز الرومي المتوفَّى عام (595هـ=1199م).
المكانة العلمية للموصل
تميَّزت الموصل منذ إنشائها بمكانةٍ علميةٍ عالية؛ فقد انتشرت بها المدارس والمكتبات العامة، كما استوطن بها كثيرٌ من العلماء وإليها نُسبوا.
المدارس
لقد كان في الموصل العديد من المدارس التي كان لها دورٌ كبيرٌ في ازدهار الحركة العلمية فيها، ومن هذه المدارس المدرسة النظامية؛ التي بناها نظام الملك الوزير المشهور في القرن (الخامس الهجري=الحادي عشر الميلادي) على غرار التي بُنيت في بغداد، وقد درس فيها من العلماء أبو حامد الشهرزوري، وأبو العباس الأنباري المعروف بالشمس الدنبلي، ومن الآثار الباقية لهذه المدرسة محراب نفيس من المرمر الأزرق المطعم بمرمر أبيض، وحول المحراب مكتوب بخط كوفي البسملة وآيات من القرآن الكريم.
وكان هناك المدرسة الأتابكية العتيقة؛ التي بناها سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر في منصف القرن السادس الهجري، وقد جعلها وقفًا على الفقهاء الشافعية والحنفية نصفين، ووقف عليها الوقوف الكثيرة، وبعد موته دُفِن بمدرسته هذه، وممَّن درس فيها: أبو البركات عبد الله بن الحسين المعروف بابن الشيرجي، الذي درس على ابن شداد العالم المشهور.
وكذلك المدرسة الكمالية؛ التي بناها زين الدين أبو الحسن علي بن بكتكين في القرن السادس الهجري، وبناية المدرسة في الوقت الحاضر تُسمَّى جامع شيخ الشط، وهي تتألَّف من غرفةٍ كبيرةٍ مثمَّنة الشكل، فوقها قبَّةٌ تستند إلى مقرنصات، وهي على ما يظهر كانت مزيَّنة بزخارف جبسيَّة من الداخل، وزخارف وكتابات آجريَّة من الخارج، ولم يزل بعض هذه الزخارف باقيًا إلى اليوم، وقبَّة المدرسة مبنيَّة من الآجر، وهي بحالةٍ يُمكن صيانتها والمحافظة عليها، وفي عام (1219هـ=1804م) رمَّم القبَّة وجدَّد بابها، وبنى أروقةً أمامها أحمد باشا بن بكر أفندي الموصلي، وأقام منبرًا داخل المدرسة واتَّخذها جامعًا كان يُعرف بجامع الشهوان؛ لأنَّه يقع في المحلة التي تسكنها قبيلة الشهوان، وفناء المدرسة واسع، كما أنَّ عددًا من الدور التي تُحيط بالمدرسة مبنيَّةٌ على أرض فناء المدرسة نفسها فهي عرصاتٌ وقفيَّة.
وهناك مدرسة الجامع النوري؛ التي بناها نور الدين محمود بن زنكي، وهي عبارةٌ عن مدرسةٍ وجامعٍ في الوقت نفسه؛ إذ رأى نور الدين إنَّه من المفيد أن يجمع بين الدين والعلم في نفس المبنى، وفي الجامع النوري خزانة كتبٍ كانت في المدرسة، وهي الكتب التي أوقفها السيد محمد بن الملا جرجيس القادري النوري الذي سعى في ترميم الجامع، واتخذ له فيه تكيَّة عام (1281هـ=1864م)، وكذلك بعض الكتب الأخرى أوقفتها عائشة خاتون بنت أحمد باشا الجليلي، ولم يكن التدريس مستمرًّا في المدرسة؛ فقد تعطَّل بها بعد العهد الأتابكي، ثم دُرس بها في فترات متباينة، ولم يبقَ لها أثرٌ في الوقت الحاضر.
المكتبات
انتشرت بالموصل عددٌ من المكتبات العامَّة، كان من أشهرها المكتبة التي أنشأها أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي السحام، في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري، وتُعتبر هذه المكتبة هي أوَّل مكتبةٍ عامَّةٍ تُوقَفُ لهذا الغرض وحده، وكانت تحتوي على كتبٍ في جميع فروع المعرفة البشريَّة، كما كانت وقفًا على كلِّ طالب علمٍ لا يمنع أحد من دخولها، وإذا جاءها غريبٌ يطلب العلم وكان معسرًا قُدِّم له المال والورق، وكانت المكتبة تفتح كلَّ يوم، وكان هناك مكانًا لمبيت الغرباء المحتاجين.
العلماء
ينتسب للموصل عددٌ كبيرٌ من العلماء، وكان فيها جماعةٌ من المؤرِّخين من أهل الموصل أو من الذين نزحوا إليها واتَّخذوها دار إقامةٍ لهم وكتبوا عنها، ومن أشهر من ينتسبون إلى الموصل؛ ابن شداد الموصلي صاحب كتاب تاريخ حلب، وهو من علماء عصره المعدودين، كان إمامًا في الدنيا والدين، وكان يُشبه القاضي أبا يوسف في عصره، و-أيضًا- المبارك بن الشعار الموصلي صاحب كتاب عقود الجمان، وأبو الحسن الهروي الرحَّالة الشهير، وله كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات.
كما اشتهر منها من علماء الدين: الفخر الموصلي، وكان بصيرًا بعلل القراءات، وله كتابٌ في مخارج الحروف، وأبو عبد الله محمد بن الحنبلي الموصلي المعروف بشعلة، كان شيخ القراء في الموصل، متضلِّعًا بالعربية والنظم والنحو، وله كتاب كنز المعاني في حرز الأماني.
واشتهر من المحدِّثين أبو زكريا يحيى بن سالم بن مفلح البغدادي الموصلي الحنبلي، حدث بالموصل وتُوفِّي بها ودُفِنَ بمقبرة الجامع العتيق، والحافظ زين الدين عمر بن عيد الحنفي الموصلي له كتاب المغني في علم الحديث، رتَّبه على الأبواب وحذف الأسانيد، ومن فقهاء الحنابلة أبو المحاسن المجمعي الموصلي الحنبلي، جمع كتابًا اشتمل على طبقات الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد، كما اشتهر من فقهاء الحنفية أولاد بلدجي.
واشتهر بها من الأطباء أبو الحسن علي ابن أبي الفتح بن يحيى كمال الدين الكباري الموصلي، عاش ما يُقارب مائة سنة، وكان من أطبَّاء زمانه، والمهذَّب علي بن أحمد بن مقيل الموصلي، وكان أعلم أهل زمانه بالطب، له تصنيفٌ حسن.
ومن الأعلام الذين سكنوا الموصل وكتبوا عنها وعن رجالها: ابن المستوفي الأربلي، وياقوت الحموي الرومي، وعبد اللطيف البغدادي، والسمعاني صاحب الأنساب، والعز بن عبد السلام وله كتاب الفتاوى الموصلية، وابن الصلاح الشرخاني الشهرزوري الملقَّب تقي الدين، كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلَّق بعلم الحديث واللغة، وله مشاركةٌ في فنون كثيرة، وهو من فقهاء الشافعية في عصره.






![نصيحتي لك: اذكر الله [1 / 12] نصيحتي لك: اذكر الله [1 / 12]](https://islamstory.com/images/upload/content_thumbs/1913613138ragheb-al-serjany-videos.jpg)
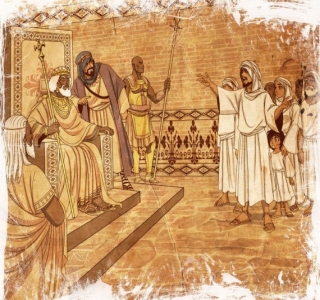

التعليقات
إرسال تعليقك